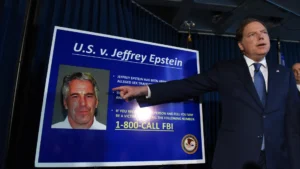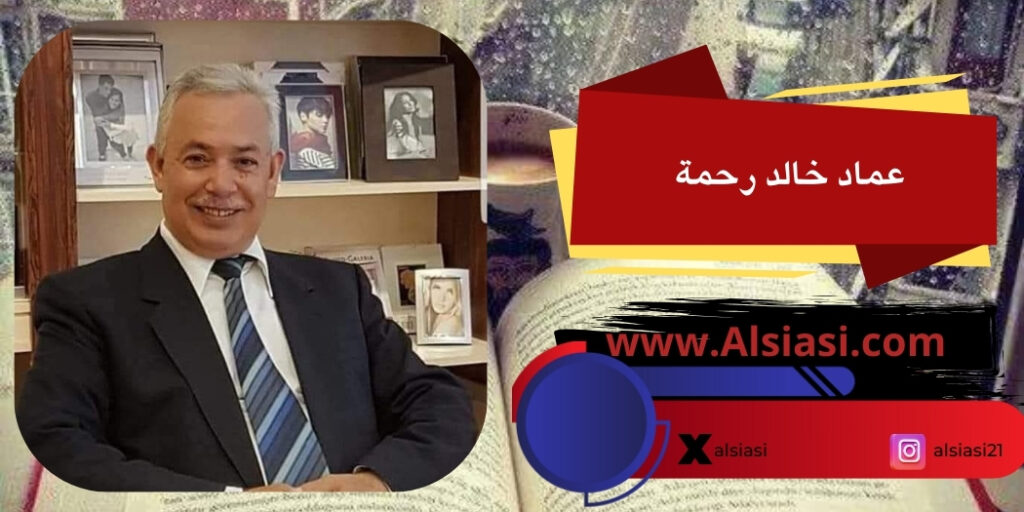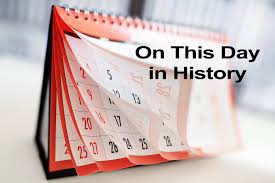لا تزال إشكالية الحرية—بمستوياتها وتشعّباتها وتجلّياتها—أشدّ الأسئلة حضوراً في الوعي العربي المعاصر، وأكثرها قدرةً على الكشف وفضح المسكوت عنه في بنية العقل الجمعي والفردي على حدٍّ سواء. فبين حريةٍ فرديةٍ تبحث عن مساحتها في عالم متغيّر، وحريةٍ جماعيةٍ تتمسّك بإيقاعها التقليدي المستمد من الذاكرة والموروث، يتشكّل صراعٌ صامتٌ حينًا، وصاخبٌ حينًا آخر، يعبّر عن أزمة بنيوية يتقاطع فيها السياسي بالديني، والفقهي بالفلسفي، والذاتي بالجماعي. إنّ هذا الجدل القديم المتجدّد لا يمكن فهمه إلا عبر العودة إلى جذوره العميقة، وتتبّع مساراته في الوعي العربي، وتحليل توتراته في ضوء شروط الحداثة وما بعدها، ورصد أثره في تشكيل المثال الأخلاقي والممارسة
في زمننا الراهن يتجدد النقاش حول الحرية وكأنّه سؤالٌ لم يُطرح من قبل، بين من يرى أنّ الحرية الفردية هي القيمة القصوى التي يجب أن يتأسّس عليها الوجود الإنساني، وبين من يعتبر أنّ الحرية الجماعية هي الإطار الذي يمنح الفرد معناه، وأنّ الخروج عنه تفككٌ ومروقٌ عن قواعد الاجتماع. وبين طرفٍ يفرد جناحيه نحو الانعتاق، وطرفٍ آخر يشدّه بسلطة التاريخ والتراث، تتأرجح الذهنية العربية مع كل موجة سياسية أو حراك اجتماعي، كأنها تعيد اكتشاف ذاتها في كل أزمة.
1. بين نسقين: الفرد والجماعة.
يتحرك الفكر العربي في مسارين متوازيين لا يلتقيان إلا لمامًا:
أحدهما يرفع الفرد إلى مقام “الذات الحرّة”، تلك القادرة على تقرير مصيرها وفق وعيها ورغباتها ومسؤوليتها الأخلاقية. والآخر يجعل الجماعة مرجعيةً نهائية لا يجوز تجاوزها، مستندًا إلى شرعيةٍ تاريخيةٍ ودينيةٍ ترى أن قيمة الفرد لا تتحقق إلا داخل بُنيةٍ أكبر تحرس النظام الأخلاقي والسلوكي.
هذا الانقسام لم يكن يومًا خلافًا نظريًا فحسب؛ فقد لامس صميم الحياة الاجتماعية، وتحوّل إلى صراعٍ بين رؤيتين: رؤيةٌ حداثية تسعى إلى إعادة بناء المفاهيم على أساس الفردانية، ورؤيةٌ تقليدية تخشى أن يؤدّي الانفتاح إلى تفكّك الموروث وضياع الهوية.
2. أثر السلطة وصنمية المثقف.
يبقى سؤال الحرية مشتبكًا مع سؤال السلطة: هل أزمة الحرية في عالمنا العربي ناجمة عن بنيةٍ سياسيةٍ مغلقة، أم عن مثقفٍ استدخل القمع وارتضى لنفسه دور “الناطق باسم الجماعة” بدل أن يكون ناقدًا لها؟
تكمن المشكلة الحقيقية في جمود المثقف الذي ورث خطابًا سلطويًا في صيغته الفقهية والتاريخية، وتبنّاه دون مساءلةٍ جذرية، فصار حارسًا للتراث بدل أن يكون مجدّدًا له. هكذا تحوّل كثير من الخطابات الفكرية إلى إعادة إنتاجٍ مُنمَّق للقديم، لا إلى مشروع نقدي يُعيد النظر في المفاهيم الكبرى كالحرية، والعدالة، والهوية.
3. الإرث الاعتزالي وعتبة الحداثة
إن العودة إلى لحظة المعتزلة ليست حنينًا فكريًا، بل ضرورة تحليلية لفهم تحوّلات العقل العربي. فقد قدّم الاعتزلة مشروعًا عقلانيًا جريئًا حاول التوفيق بين الإيمان والعقل، وبين الحرية والإرادة، وبين النص والوجود. إلا أنّ هذا التيار—رغم ثرائه—لم ينجُ من سياقات الصراع السياسي، فاستُخدم أحيانًا كأداةٍ سلطوية، كما في محنة خلق القرآن، مما جعل التجربة تنتهي بجرحٍ عميق في الوجدان الإسلامي، وأدّى إلى موجةٍ من الانغلاق والتشدد تواصلت قرونًا طويلة.
ومع ذلك، تظل التجربة الاعتزالية أقرب ما تكون إلى محاولة تأسيس حداثة عربية مبكّرة، أجهضتها السياسة قبل أن تكتمل.
4. الحرية الجماعية: عقدٌ أخلاقيّ وسياسيّ.
الحرية الجماعية تتأسّس على مفهوم “التعاقد الاجتماعي” في صورته الإسلامية والعربية: حريةٌ يتنازل فيها الأفراد طوعًا عن جزءٍ من رغباتهم لصالح المصلحة العامة، حمايةً للسلم الأهلي، ولضمان التكافل والاستمرار. هذه الرؤية—على أهميتها—تخسر قيمتها عندما تتحوّل من عقدٍ اختياريّ إلى وصاية، ومن توافقٍ إلى قسر، ومن حمايةٍ إلى قمع باسم “الهوية” أو “المصلحة العامة”.
فالجماعة التي تخاف من الفرد تُنتج طغيانًا ناعمًا، يختبئ وراء الخطاب الأخلاقي، ويبرع في ترويض الوعي وجعله يدافع عن سجّانه.
5. الحرية الفردية: سؤال الخصوصية وامتحان الهوية
على الجانب الآخر، تطرح الحرية الفردية إشكالاتٍ معقّدة في مجتمعٍ يهيمن عليه البُعد العشائري والديني. إنها حريةٌ مشاكسة، عصيّة على الاحتواء، لأنها تمسّ الجسد، والهوية، والضمير، والاختيار، والتنوّع، وتعيد رسم الحدود بين الذات والآخر.
هذه الحرية ليست تمرّدًا، بل إعادة تعريفٍ للوجود الإنساني: ماذا يعني أن تكون نفسك؟ ماذا يعني أن تملك قرارك؟ وكيف يمكن للعقل أن يخلق فضاءه الخاص دون الاصطدام بالمقدّس وبالحدود الاجتماعية؟
تحتاج الحرية الفردية إلى قوانين تحميها، لكنها تحتاج أكثر إلى ثقافةٍ تستوعبها. فالقانون وحده عاجز عن بناء مجتمع حرّ إن لم يكن الوعي نفسه قد تحرّر.
6. نحو مفهوم جديد للحرية: جدل لا بد من حسمه.
إنّ التوتر بين الفرد والجماعة ليس قدرًا أبديًا؛ بل يمكن تحويله إلى تكاملٍ خلاق إذا أعيدت صياغة المفاهيم ضمن رؤيةٍ جديدة تُوازن بين احترام الخصوصية الفردية وصيانة العقد الاجتماعي.
الحرية ليست انعتاقًا بلا حدود، ولا قيدًا بلا نهاية.
إنها مساحةٌ من الضوء يقف فيها الفرد والجماعة معًا، حيث تُصان الكرامة، ويُعترف بالتنوّع، ويُفهم الاختلاف بوصفه ثراءً لا تهديدًا.
خاتمة:
إنّ سؤال الحرية—بفرادته وجماعته—هو سؤال وجودٍ قبل أن يكون سؤال قانونٍ أو سياسة. ونحن اليوم، في زمن التشظّي والتحوّل، أحوج ما نكون إلى إعادة بنائه بمنهج فلسفي يعيد الاعتبار للعقل، ويحرّر الفكر من صنمية الماضي، ويضع الإنسان، كل إنسان، في مركز المعادلة.
فلا جماعة قوية بلا أفراد أحرار، ولا فرد حرّ في ظلّ جماعةٍ تجهل أنّ الحرية ليست نقيض الهوية… بل شرطها.