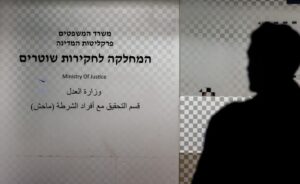لا يمكننا التغاضي عن ضرورة ربط الماضي المنظور للثقافة العربية بحاضرها الصعب والبائس، لما تعانيه من تشتّت وتمزّق تمارسه الخصوصيات الثقافية الضيقة، وتهدّده الهويات الفرعية القاتلة. ذلك أنّ المفهوم الرسمي العربي للظاهرة الثقافية ما يزال غامضًا ومبهمًا حتى يومنا هذا، لأنه محكوم بظروفٍ خاصّة ومعطياتٍ لحظيّةٍ ظرفية، وبعوامل داخليةٍ وخارجيةٍ ضاغطةٍ بشكلٍ كبير.
من هنا، يشكو الخطاب الرسمي العربي الخاص بالثقافة من التناقض وعدم التماسك، ويؤكّد للجميع فقدانه البوصلة، مُعلنًا فشله في مواجهة فكرة أنّ العولمة الاقتصادية والسوق العالمي الحر وانتشار الثقافات عبر القارات والقوميات هو “قضاءٌ وقدرٌ” لا فكاك منه، بشرط الحفاظ ـ قدر الإمكان ـ على الهوية العربية وخصوصياتها الحضارية الغنية.
هذا التشتّت وعدم التماسك يدفعنا إلى الحديث بشفافية عن مكوّنات الثقافة العربية، من خلال موقع الوطن العربي الجغرافي، وما يملكه من موارد طبيعية وثروات مالية ضخمة، وما يسير عليه من نظمٍ سياسيةٍ خاصّة، مع ضرورة التعمّق في دراسة أوضاعه التنموية والسكانية، وطبيعة علاقاته البينية وعلاقاته مع بقية دول العالم، وموقعه الجيوسياسي والاستراتيجي.
من هنا نرى أن العولمة، بما تملكه من فضاءٍ واسع، لا تعني بالضرورة القضايا ذاتها التي يعانيها وطننا العربي، ولا تنطوي على التحدّيات نفسها، أو على الأقل بالنسبة لكلّ مجموعةٍ من مجتمعاتنا. كما أنّ التعدّد الثقافي الواسع، في ظلّ الافتراق والتباين، موجودٌ بقوة، وهو ما يُميّز الثقافة العربية بخصوصياتٍ لا تنفي مفهومها العام، بل تزيده غنىً وثراءً وخصوبةً. ويبقى المشترك العام باسم الخصوصية هو الأهمّ.
المؤلم في الأمر أن يُسقِط البعض التشتّت والضياع السياسي العربي على القضايا الثقافية، فيُحاكِم الثقافةَ ومحمولاتها طبقًا لمعايير السياسة وموازينها. ولا يقلّ خطورةً أن نُضخّم الخصوصيات الفرعية وننفي المشترك العام باسم “الخصوصية”، لأن في ذلك وأدًا لأيّ حركةٍ طائفيةٍ أو مذهبيةٍ أو إثنيةٍ ناشئة، تهدّد بنية الهوية الجامعة. إنّ الثقافة العربية تضمّ بين جنباتها تياراتٍ وخصوصياتٍ متعددة تصبّ في مجرى واحدٍ منسجم، دون إقصاءٍ أو تهميشٍ أو استبعادٍ لأيّ مكوّن من مكوّناتها الاجتماعية.
في هذا السياق، ومع معاناتنا نحن العرب من العجز والتراجع، لا ينبغي أن نُحمّل الآخر الغربي كامل مسؤولية تخلفنا، فهناك من يعزون كلّ ما نعانيه من ظلمٍ وإجحافٍ إلى الخارج. وهذا التبرير لن يُمكّننا من التقدّم خطوةً واحدة إلى الأمام. المطلوب هو أن نتحرّر من هذه النزعة الاتكالية، وأن نُجري تغييراتٍ بنيويةٍ جوهرية في ثقافتنا، تتضمّن الاعتراف بمسؤوليتنا المباشرة عن أزماتنا الراهنة، والبحث الجادّ عن مصائرنا ومستقبلنا ووجودنا المحلي والإقليمي والعالمي، وعن حقيقة هويتنا وكيفية الحفاظ عليها في مواجهة تيّار العولمة الجارف.
لقد ظهرت تياراتٌ عربية متباينة في تعاملها مع الظاهرة الثقافية:
_ التيار القومي الذي يشعر بعدم الاستقرار والعجز عن تحقيق الحلم العربي الكبير، فحاول دمج الظاهرة الثقافية بالهمّ السياسي العام.
_ التيار الليبرالي الذي يرى في العولمة ظاهرةً لا يمكن التراجع عنها، وعدّها السبيل الأجدى للبقاء عالميًّا.
_ التيار الماركسي الذي سعى إلى كشف أنساق الثقافة العولمية ونتائجها بالالتقاء مع اليسار الغربي، فبقي غالبًا مرتبطًا بالنظم الشمولية، خلافًا للِّيبراليين الجدد.
_ التيار الإسلامي الذي حاول الدمج بين عالمية الإسلام والعولمة ضمن أنساقٍ محدّدةٍ يوجّهها فكرٌ عقديٌّ خاصّ.
لقد أسهم النظام الثقافي العربي ـ للأسف ـ في إبعادنا عن دائرة المشاركة العملية في النظام الثقافي العالمي، وجعلنا أسرى ثقافةٍ استهلاكية، إذ حوّل الثقافة التراثية الغنية إلى قلاعٍ حصينةٍ مغلقة لا تطالها رياح التغيير، فبقيت أسيرة الماضي والتقليد. ولا شك أنّ أزمة الثقافة العربية هي جزءٌ لا يتجزأ من أزمة الدولة العربية ذاتها، ومن البنية الاجتماعية ـ الاقتصادية المتصدّعة. فهي أزمة وعيٍ وفكرٍ وفعل، حيث يتجلّى الخلل البنيوي في العلاقة بين الوعي والفعل: وعيٌ غير مكتمل وفعلٌ عاجز.
إنّ أزمة الثقافة العربية المعاصرة تُعبّر عن غياب القدرة على اتخاذ موقفٍ حاسم، وعن تصدّع الطبقة الوسطى التي حملت مشروع النهضة، تلتها مرحلة البترودولار التي أنشأت مجتمعًا استهلاكيًّا غير منتج، ثمّ مرحلة الدولة الأمنية الفاسدة التي أفسدت المجتمع بكامله.
إنّ إنقاذ الثقافة العربية والمحافظة على هويتها وخصوصيتها يرتبط بتحقيق التنمية الشاملة، وتوسيع مجالات الديمقراطية، وتفعيل قيم الحوار والتعدّدية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني المستقلّة، وبناء أنظمةٍ تعليميةٍ حديثة تُحرّر العقل وتدفعه نحو الإبداع والإنتاج، مع ضرورة محاربة الأمية وتعزيز المشاركة الشعبية، ورفض الشمولية الثقافية والسياسية.
تتعدّد الرؤى حول بنية الثقافة العربية واندماجها الجزئي في الثقافات العولمية: فهناك من يرى أنّ للعولمة أثرًا سلبيًا على الهوية العربية، فيما يرى آخرون أنّها تُتيح فرصًا للمواكبة والانفتاح. وكلا الطرفين على صوابٍ من زاويةٍ ما، إذ إنّ إصلاح الداخل العربي هو الشرط الأول لأيّ تفاعلٍ متوازنٍ مع الخارج.
لقد انفتحت مجتمعاتنا على مصراعيها أمام الغزو الثقافي الغربي، مما أدّى إلى تهميش اللغة العربية والتعليم وإضعاف التربية، وظهور مظاهر التقليد الأعمى في أنماط العيش والسلوك، وسط غياب استراتيجيةٍ ثقافيةٍ عربيةٍ موحّدة. وقد أسهم هذا في إضعاف منظومة القيم والأخلاق، وزعزعة الهوية الأصيلة التي كانت تُشكّل نسيج الوعي العربي الجمعي.
إنّ أهدافنا الثقافية تبقى ثابتة، لكن الوسائل تتبدّل وتتطوّر، ومن ثمّ لا بدّ من التحصين الداخلي، وتثبيت الأخلاق والقيم والمبادئ والعادات التي نؤمن بها، مع الانفتاح الذكي على ثقافات العالم، وإتقان استخدام أدوات الإعلام والتكنولوجيا الحديثة. كما يجب فتح مجالات حرية الرأي والتعبير وقبول النقد والآخر، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع الحفاظ على الثوابت والمرتكزات العربية، ودعم اللغة العربية والتعليم في مختلف مراحله، بما يُسهم في تطوير الثقافة العربية ودفعها لتصبح ثقافة عالمية، كما كانت في فتراتٍ مشرقة من حضارتنا العربية الإسلامية.